بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، تصاعدت على منصات التواصل الاجتماعي حملات مٌسبقةومشبوهة تتبنى أطروحات متناقضة ظاهرها النقد وباطنها الطعن في هوية مصر الدينية والحضارية، وتصدّر المشهد بعض المنتمين إلى تيارات أيديولوجية مختلفة، تتفق فقط في عدائها للدولة المصرية الراهنة.
تمحورت هذه الحملات حول فكرة أن الملك رمسيس الثاني هو فرعون موسى عليه السلام، وأن الاحتفال بافتتاح المتحف وما أُنفق عليه من موارد الدولة ما هو إلا "مخطط ماسوني" ضمن مشروع "الحكومة الخفية" لإعادة "فرعنة مصر"، أي سلخها من هويتها العربية والإسلامية، وتحويلها إلى دولة "وثنية بلا دين".
وقد تبدو هذه الفرضية عند أول فحص عقلاني أقرب إلى إشكالية الهوس التآمري منها إلى التحليل العلمي الدقيق، وسأحاول في هذا المقال، بهدوء وموضوعية، تفكيك هذه الرؤية ومناقشتها من منظور علمي وتاريخي وديني ومنطقي، معتمدين على النصوص الدينية، والحقائق الأثرية، ومصادر الدراسات الحديثة.
أولًا: نظرية المؤامرة... حين يغيب العلم ويعلو الظن
تُعرَّف نظرية المؤامرة بأنها تفسيرٌ للأحداث يقوم على افتراض وجود مخطط سري من مجموعة قوية ذات نوايا شريرة، غالبًا ما تكون سياسية أو دينية أو اقتصادية، تسعى من خلاله للتحكم في مجريات العالم.
وتقوم نظرية المؤامرة عادةً على أربع ركائز:
- الأولى: التركيز على فكرة التآمر والسلطة الخفية؛ حيث يُعتقد بوجود جماعات سرية تدير العالم في الخفاء.
- الثانية: الاعتماد على المشاعر والأدلة الضعيفة بدلًا من التحليل الموضوعي، مستغلةً الحس الديني والاجتماعي للناس.
- الثالثة: الترابط المستمر بين الأحداث، بحيث يُفسَّر كل شيء كجزء من مؤامرة كبرى لا تنتهي.
- الرابعة:الاستخدام السياسي؛ إذ تُستعمل هذه النظريات أحيانًا من الأنظمة الحاكمة المستبدة أو المعارضة المتطرفة لتبرير الفشل أو لتعبئة الجماهير ضد "عدوٍّ وهمي".
لكن حين نُخضع هذه الفكرة للمنطق، يتضح أن الحضارات لا تُبنى بمؤامرات، بل بالتراكم المعرفي والإرادة الوطنية، والفيلسوف النمساوي الإنجليزي كارل ريموند بوبر المتخصص في فلسفة العلوم. والذي يعتبر أحد أهم وأغزر المؤلفين في فلسفة العلم في القرن العشرين، والذي كتب بشكل موسع عن الفلسفة الاجتماعية والسياسية، يرى أن تلك النظرية تُبنى على وهمٍ بأن الأحداث الكبرى لا يمكن أن تقع إلا بتصميم واعٍ من فاعلين متآمرين، لا كنتيجة لتفاعلات اجتماعية واقتصادية معقدة.
لقد واجهت مصر عبر تاريخها أعتى الغزوات وأقوى المؤامرات تعقيدا، لكنها ظلت - وفق العقيدة الراسخة في وجدان أبنائها - بلدًا محفوظًا بحفظ الله، وهو ما استمده المصريون من عقائدهم الدينية، ففي القرآن الكريم، أكد النص القرآني في مواضع عدة هذا السند، في قول الله تعالى: {اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ} [البقرة:61]، وفي قوله الكريم: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسف:99]، وفي قول الله لموسى عليه السلام: {أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [يونس:87]
ولم يخلْالحديث النبوي الشريف، من وصية الرسول عن مصر وأهلها، فقد جاء في الحديث الشريف:«استوصوا بأهل مصر خيرًا، فإن لهم نسبًا وصهرًا»، وأيضا: «إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض».
وفي الأثر التاريخي، أن "الحجاج بن يوسف الثقفي" قال: عن المصريين في وصيته للقائد "طارق بن عمرو": (لو ولاك أمير المؤمنين أمر مصر فعليك بالعدل، فهم قتلة الظلمة وهادمو الأمم، وما أتي عليهم قادم بخير إلا التقموا كما تلتقم الأم رضيعها وما أتي عليهم قادم بشر إلا أكلوه كما تأكل النار أجف الحطب، وهم أهل قوة وصبر وجلده وحمل، ولا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ماتركوه إلا والتاج علي رأسه، وإن قاموا علي رجل ماتركوا إلا وقد قطعوا رأسه، فأتق غضبهم ولا تشعل نارًا لا يطفئها إلا خالقهم، فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض، وأتق فيهم ثلاثًا: نسائهم فلا تقربهم بسوء، والا أكلوك كما تأكل الأسود فرائسها - ارضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم - دينهم وإلا أحرقوا عليك ديناك، وهم صخرة في جبل كبرياء الله تتحطم عليهم أحلام أعدائهم وأعداء الله).
ومن ناحية أخرى، لطالما حجزت مصر مكانةً متميزة فى صفحات الكتاب المقدس، ليس فقط كأرض ذات تاريخ عريق، بل كرمز روحي له دلالاته العميقة فى مسيرة الخلاص الإلهي،وبين سطور العهدين القديم والجديد، تتكرر الإشارات إلى مصر، إما كملجأ، أو كرمز لمحبة العالم، أو كمسرح لعمل الله وسط الأمم، فقد وردت كلمة "مصر" فى الكتاب المقدس، فى العهد القديم 563 مرة، وفى العهد الجديد 23 مرة،ووردت كلمات مصري،مصرية، مصريون 122 مرة،والمجموع 708 مرة.
وتُعد مصر واحدة من أبرز المحطات فى قصة السيد المسيح عليه السلام وفي العهد القديم، إذ لجأت إليها العائلة المقدسة (السيد المسيح وأمه السيدة مريم العذراء ويوسف النجار) هربًا من بطش الملك هيرودس الذي تخوف من أن يزاحمه المسيح في الملك، فى مشهد يُجسد مصر كأرض احتضان وحماية،أيأن مصر كانت ملتجئاآمنا وسلاما للعائلة المقدسة،اما مسار ها فى مصر فيكفى أن يثبت أن مصر هي الملاذ الآمن، وهو المسار الذي بدأ ببلدة الفرما في شمال سيناء واستمر حتى أسيوط في جنوب مصر ( نحو 3500 كم ذهابا وإيابا)أي من شمال مصر إلى جنوبها في مأمن كامل.
وذكر الكتاب المقدس عن مصر الكثير في مكانتها وحفظها مثل ما ورد في الآيات: من مصر دعوت ابني (هوشع 10:11)،كجنة الرب كأرض مصر (تكوين 10:13)،مباركشعبي مصر (أشعيا 25:19)،جاءت كل الارض الى مصر الى يوسف لتشتري قمحا (لاحظ كلمة كل الارض). جاء ابرام الى مصر لأن الجوع فى الارض كان شديدا (تكوين 10:12).
ثم نتذكر مقولة قداسة البابا تواضروس الثاني الشهيرة: "إن كان العالم كله محفوظ فى يد الله فان مصر محفوظة فى قلب الله". وهو تعبير يفسر العلاقة الفريدة بين مصر والإرادة الإلهية عبر العصور.
·وهذا غيض من فيض والباقي كان اعظم، مما يرسخ من عقيدة المصريين أنهم محصنون ضد المؤامرات وأن تاريخهم يثبت أنهم دائما ينتصرون على كل مؤامرة، وأن هذا في عقيدة كل مصري نابع من عقيدته الدينية، ففي ضوء النصوص الدينية من القرآن الكريم والكتاب المقدس، تبدو مصر عبر التاريخ أرض الرسالات والنجاة لا المؤامرات، ومصدر الإيمان لا الوثنية، ورغم ما يُثار عن «نظرية المؤامرة» في الوعي الجمعي المصري، فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن عقيدة المصريين الدينية راسخة الجذور في يقينهم بأن الله حافظ هذا البلد وأهله، وأن كل المؤامرات التي تُحاك ضدهم مآلها إلى الزوال.
هذا لا يعني بطبيعة الحال إنكار وجود مؤامرات بالفعل تُدبَّر ضد مصر وشعبها ومكانتها، فالدول الكبرى لا تتورع عن استخدام كل أدوات الضغط والتشويه والتأثير لتحقيق مصالحها، غير أن التاريخ - القريب والبعيد - يبرهن على أن مصر كانت دومًا قادرة على إفشال تلك المخططات، لأن سر قوتها لا يكمن فقط في موقعها الجغرافي، بل في وعي شعبها وعمق حضارتها التي علمت الدنيا معنى البقاء بعد كل عاصفة، إنها الدولة التي حاول الغزاة احتلالها، والمستشرقون تشويهها، والمغرضون إسقاط رموزها، فبقيت واقفة، وذهبوا هم إلى النسيان.
ثانيًا: المتحف المصري الكبير... إنـجاز وطني لا مؤامرة حضارية
من يتأمل المتحف المصري الكبير يدرك أنه ليس مشروعًا أثريًا فقط، بل رمز حضاري شامل لنهضة الدولة المصرية الحديثة، ويقع المتحف على مساحة تزيد على 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من عصور مختلفة، منها كنوز الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد، ويعكس هذا عدة مؤشرات منها:
1. النجاح في الإنـجاز:
هذا المشروع تم بناؤه بتمويل أغلبه مصريبعد تعثر دام سنوات، ليخرج إلى النور بأيدي المهندسين والعمال المصريين، ثم إن افتتاحه بعد عقدين من الإعداد والتنفيذ يمثل نموذجًا للقدرة الإدارية والتخطيط طويل المدى، ورسالة واضحة بأن مصر قادرة على تحويل الحلم إلى حقيقة رغم كل التحديات الاقتصادية والسياسية.
2. العائد الاقتصادي:
ما هو متوقع، أن يصبح المتحف المصري الكبير أكبر مقصد أثري وسياحي في العالم، بما يرفع عدد السائحين في مصر إلى أكثر من 15 مليون زائر سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقًا لتقديرات البنك الدولي ووزارة السياحة، وسيُدر على الدولة مليارات الدولارات من العملة الصعبة، فضلًا عن خلق عشرات الآلاف من فرص العمل في قطاعات النقل، والخدمات، والإعلام، والصناعات الثقافية.
إن منطق العلم والاقتصاد يؤكد أن افتتاح هذا الصرح ليس مؤامرة، بل استثمار في الهوية والتاريخ، وتحقيق لواحد من أكبر مشاريع القوة الناعمة في الشرق الأوسط.
إنه مبرر قوي للاستفادة من آثار مصر والتي ظل أغلبها مدفونا تحت الأرض، لتصنع مسارا اقتصاديا هامة يساهم بعوائده في التنمية الشاملة وتحسين دخل ومعيشة المواطن، وهو الأمر الذي لا يجب أن يتوقف عند المهاترات الجدلية.
ثالثًا: هل كانت مصر القديمة دولة كافرة؟
هنا تكمن مغالطة كبرى في سردية "المؤامرة"، فالمصريون القدماء لم يكونوا كفارًا كما يُصوّرهم البعض، بل كانوا أصحاب فكر ديني توحيدي متطور، تجلّى في إيمانهم بالخلق والحياة الأخرى والحساب، وهي مفاهيم تسبق كثيرًا من الحضارات اللاحقة.
والتوحيد كان جوهر العقيدة المصريةالقديمة، وتعدد أسماء الآله والرموز في الديانة المصرية القديمة لم يكن دليلًا على الشرك، بل على تعدد صفات الإله الواحد؛ فـ"رع" يمثل النور، و"أوزيريس" يمثل البعث، و"آمون" يمثل الخفاء والقوة الإلهية، وكانت النصوص الجنائزية مثل "كتاب الخروج إلى النهار" تُظهر إيمانًا عميقًا بـ الحياة الأبدية والحساب بعد الموت، وهي عقيدة تتسق تمامًا مع الإيمان بالله واليوم الآخر.
وقد كان للأنبياء رسالة ورحلة طويلة في أرض مصر منذ بدء التاريخ البشري، فقد ذكر القرآن الكريم النبي إدريس عليه السلام ضمن أوائل الأنبياء، في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ٥٦ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧}[مريم:56، 57]، وقد أجمع كثير من المفسرين على أنه عاش في مصر القديمة، وقد جاء في البداية والنهاية لابن كثير، أن إدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه، ووصفه بالنبوة والصديقية، وهو في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما ذكره غير واحد من علماء النسب، وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام، وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم.
أما الأنبياء الذين عاشوا في مصر، فغير إدريس عليه السلام، والذي يُعتبر أول نبي أُرسل إلى مصر، وعاش فيها وعلّم الناس علومًا كثيرة، يوجد نبي الله يوسف عليه السلام، وقد عاش في مصر وعمل فيها، وتميز بذكائه وحكمته حتى أصبح عزيز مصر وحاكم خزائنها، وموسى عليه السلام، والذي وُلد وتربى في مصر في كنف آل فرعون، وهو المكان الذي اختاره الله ليُكلمه فيها في جبل طور سيناء، وهارون عليه السلام،شقيق موسى، الذي رافقه في مصر وكان وزيره ومتحدثه، وسيدنا يعقوب عليه السلام الذي جاء إلى مصر مع أبنائه الأسباط للعيش فيها، ويوشع بن نون، فتى موسى، ويُعتقد أنه ولد وتربى في مصر.
كما تذكر يعض الروايات أن ولي الله العبد الصالح الخضر عليه السلام، قد عاش في مصر.
أما الأنبياء الذين مروا بمصر، منهم خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام،والمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، كما ذكرنا.
كما أن موسى عليه السلام أُرسل إلى فرعون وملئه ليدعوه إلى الإيمان بالله، ولم تكن رسالته إلى شعب مصر كله، وهو ما تدل عليه الآية:{اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [طه:24]، وكان فرعون هو الحاكم المستبد الذي اضطهد بني إسرائيل، وكانت الدعوة موجهة بالأساس إلى إقناعه بترك بني إسرائيل وشأنهمفلو كانت مصر كلها كافرة، لما خصّ الله نبيه برسالة موجهة إلى طاغية بعينه، فالهدف الرئيسي من بعثة موسى عليه السلام، هو مواجهة فرعون وقومه المستكبرين الذين استعبدوا بني إسرائيل، ومن الأدلة على ذلك أيضا ما أشار إليه القرآن الكريم، من أن فرعون هو من هلك هو وأتباعه، وأن الذين لم يهلكهم الله هم من لم تصلهم الدعوة بشكل كامل، مثل من حضروا مسابقة السحرة دون أن يلتزموا بالدخول في الدين، وهناك تمييز واضح بين فرعون وقومه الذين آمنوا به وبين الشعب المصري الذي لم يكن معنيًا بالصراع، بل كان ضحية لاستبداد فرعون.
رابعًا: هل رمسيس الثاني هو فرعون موسى؟
الجدل حول شخصية "فرعون موسى" مستمر منذ قرون، لكن الأدلة الأثرية والعلمية تُضعف بشدة فرضية أن يكون رمسيس الثاني هو المقصود، فرمسيس الثاني حكم أكثر من 66 عامًا (1279–1213 ق.م)، وكان من أعظم البنّائين في التاريخ، خلف وراءه عشرات المعابد والتماثيل والنقوش. ولم يثبت علميًا أو أثريًا أنه مات غرقًا، كما ورد في القرآن عن مصير فرعون موسى.
وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ} [الأعراف:137]، وتمثال رمسيسالثاني الموجود بيننا حاليا، وهذا الكم الهائل من آثاره الحالية والمنتشرة في كل مكان وفي المتحف المصري الكبير والآثار الشاهدة عليه داخل مصر وخارجها تؤكد عكس ما ورد بالآية الكريمة، وبكل تأكيدأن فرعون موسى ليس له أثر في حياتنا اليوم بالاستناد إلى مرجعية الآية الكريمة.
كما أن رمسيس الثاني أنجب أكثر من 100 من الذكور والإناث، في حين أن فرعون موسى - حسب ما ورد في النصوص - لم يكن له وريث، وهو ما دفعه إلى قتل أبناء بني إسرائيل خوفًا على ملكه، وفي القرآن الكريم جاء قول الله تعالى على لسان امرأة فرعون: {وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} [القصص:9]، أي لم يكن له ولد قبل موسى.
ثم إن لفظ "فرعون" نفسه لم يكن لقبًا ملكيًا في العصور القديمة، بل من المرجح أنه كان اسمًا لشخص بعينه، وهو على الأرجح اسم الفرعون الذي واجه موسى، ويُستدل على ذلك من الاستخدام القرآني للفظ آل فرعون، إذ أن كلمة "آل" لا تُضاف إلا إلى اسم شخص كما ورد مع (آل إبراهيم، آل يعقوب، آل عمران، آل لوط)، وليس إلى لقب وظيفي.
ولعل من أسباب الاختلاف (في تحديد فرعون موسى) أن القرآن الكريم لم يذكره بالاسم (كما جاء في التفسيرات)، ولم يحدد تاريخ انفلاق البحر، واكتفى باستعراض مشهد الهروب أثناء حديثه عن قصة موسى عليه السلام.
لكن يعض الآراء عن تاريخ مصر القديمة يمكن أن يشير إلى أن (فـرعون) ليس اسمًا بل لقبًا كان يتم إضفاؤه على ملوك مصر القدماء - غير أن الدكتور سعيد ثابت (وهو باحث أثري من جامعة القاهرة) يذكر أن فرعون موسى كان استثناءً، وأن «فرعون» كان اسمه وليس لقبه، كما هو معـتـقد، ويقول: إن «الملك فرعون» بلغ من القوة والعظمة حد إطلاق لقب «فرعون» على كل من جاء بعده من ملوك مصر.
وأنا شخصيًا قد لا أستبعد هذا الاحتمال، لأنه لو كان تفسير أن (فرعون) لقب الملك وليس إسم، فإن ذلك قد يدحضه أن القرآن الكريم لم يكن عاجزًا عن ذكر اسمه الحقيقي (كما ذكر اسم قارون وهامان في سورة العنكبوت)، لكنني أتصور أن تفسير كلمة "فرعون" لقبًا عامًا لملوك مصر لا اسمًا لشخص بعينه، قد يتعارض مع دلالة الخطاب القرآني الدقيقة؛ فاقتصار الوصف على لفظ "فرعون" هو في حقيقته نداء بالاسم لا بالوظيفة، وفي ذلك تقليل مقصود له، إذ رغم ما كان عليه من ملكٍ وجبروتٍ وادعاءٍ للألوهية، لم يُنَادَ في كتاب الله بلقبه الملكي كما يُفعل مع الملوك، بل نُودي باسمه ليبقى رمزًا للطغيان والغرور الإنساني، لا تجسيدًا لمقام ملكٍ أو سلطانٍ زائل، والله أعلم.
وقد يؤكد هذا أن القرآن الكريم حين أراد الحديث عن الحكام الذين كانوا ملوكًا حقًا، استخدم اللفظ صريحًا كما في قوله تعالى: "وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان..." في قصة يوسف عليه السلام، وكما وصف داود وسليمان بقوله: "وشددنا ملكه" و*"هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي".
ومن ثم، فإن اختيار القرآن للفظ "فرعون" دون غيره يحمل دلالة مخصوصة، قد تعبر (والله أعلم) عن شخص محدد أكثر مما تعبر عن وظيفة، وتبقى شاهدًا على عدل الله وحكمته في التفريق بين الملك العادل والطاغية المتجبر.
ورغم أن كثيرًا من الآراءتدعي القول بأن رمسيس الثاني هو فرعون موسى، فإن هذا الربط لا يقوم على أساس علمي أو تاريخي قاطع. فالثابت أن نبي الله موسى عليه السلام عاش مائةً وعشرين عامًا، وبدأ دعوته لفرعون وهو في الثمانين من عمره، واستمرت المواجهة بينهما نحو أربعين عامًا حتى أغرق الله فرعون وجنوده، فقد ذكر المفسرون من أهل العلم أن موسى عليه السلام دعا على فرعون أربعين سنة قبل أن يستجيب الله دعاءه ويهلكه وجنده، وهو ما يجعل هذه المدة ثابتة في معظم الروايات التفسيرية.
ولو افترضنا أن رمسيس الثاني هو هذا الفرعون، لكان عمره وقت الغرق يقارب السبعين عامًا فقط، إذ تولى الحكم وهو في الثلاثين من عمره، واستمر حكمه نحو ستةٍ وستين عامًا حتى توفي في السادسة والتسعين ميتة طبيعية ودُفن في مقبرته المعروفة بوادي الملوك، ولا توجد أي دلائل أثرية أو علمية على أنه مات غرقًا أو فُقدت جثته في البحر كما ورد في القصة القرآنية.
وبالحسابات الدقيقة، فإن رمسيس الثاني لو كان فرعون موسى، وتولى الحكم في سن الثلاثين، فإنه كان بلا ولد أو نسل في ذلك العمر،بدليل ما فسرهالعلماء والمؤرخون عن آيات القرآن الكريم، عن فكرة تبنيه لطفل - هو موسى عليه السلام –وهو أمر غير ممكن منطقيًا ولا تاريخيًا، إذ يستحيل أن يتبنى رجل لم يُرزق بعد بأبناء طفلًا رضيعًا يكبره في العمر لو صحّت المقارنة الزمنية بين ميلاد موسى وتولي رمسيس الحكم.
بل إن كل المعادلات الزمنية تشير إلى أن موسى عليه السلام لو عاش في عهد رمسيس الثاني لكان أكبر منه بما لا يقل عن خمسين عامًا تقريبًا، وهو ما يتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم والتاريخ معًا من أن موسى تربّى رضيعًا في بيت الفرعون نفسه، في زمنٍ كانت فيه السلطة والجبروت بيد هذا الفرعون، لا في عهد من هو أصغر منه سنًا، ومن ثمّ، فإن هذا التناقض الزمني والمنطقي يدحض بقوة فرضية أن يكون رمسيس الثاني هو فرعون موسى.
خامسًا: من المستفيد من "تفرعُن" مصر؟
من أطلق مصطلح "الحضارة الفرعونية" لم يكن مصريًا، لكنه سير وليام ماثيو فلندرز پتري،وكان عالم مصريات إنجليزي من أصل يهودي، ورائد منهاج منظم في علم الآثار. وقام بالتنقيب عن الآثار في العديد من أهم المواقع الأثرية في مصر مثل أبيدوس والعمارنة. ويعتبر البعض أن أهم اكتشافاته هي لوحة مرنبتاح، وبدأ حفريات في عدة مواقع هامة في المنطقة الجنوب غربية لفلسطين، وبعد تقاعده، انتقل بشكل دائم إلى القدس، حيثُ عاش مع زوجته في المدرسة البريطانية لعلم الآثار، ثم عمل مُؤقتًا في المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية، ومات في 28 يوليو 1942، ودفن بالقدس.
وهذا العالم كان أول من رسّخ هذا الوصف في الأبحاث الغربية، وربما كان في ذلك قصد أو عمد (مجرد تحليل غير موثق) في أن يحول الحضارة المصرية التوحيدية إلى حضارة "وثنية" في نظر أوروبا، متجاهلًا أن مصر كانت مسرحًا للأنبياء وللنجاة الإلهية عبر العصور، وبهذا، خدم قد يكون هذا المكتشف قد خدم سردية توراتية تهدف إلى تصوير المصريين كأعداء لله وأنبيائه، لتبرير الاحتلال والتفوق الغربي فيما بعد.
لكن الحقيقة أن مٌلك آل يعقوب كان في مصر بفضل يوسف عليه السلام، وأن العائلة المقدسة مرت فيمصر بأمان، وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أوصى بأهلها خيرًا، فكيف يمكن أن تكون هذه الأرض كافرة وهي مهبط الوحي وملجأ الأنبياء؟
سادسًا: حفل الافتتاح... تتويج لعقود من العمل ورؤية قيادة
جاء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا عالميًا بكل المقاييس، ليس فقط لأنه يضم أندر مقتنيات التاريخ الإنساني، بل لأنه يعكس قدرة الدولة المصرية الحديثة على تنظيم حدث حضاري بمستوى يليق بمكانتها العالمية.
والتحضيرات التي سبقت الافتتاح استمرت لسنوات من العمل العلمي والهندسي والثقافي المتكامل، شارك فيه آلاف الخبراء والمهندسين والمرممين من مصر وخارجها، في واحدة من أعقد عمليات النقل والترميم في التاريخ الحديث.
وقد تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع منذ بداية عهده، مؤكدًا أن المتحف ليس فقط صرحًا أثريًا، بل أداة لتوظيف الموارد الحضارية في خدمة الاقتصاد الوطني، وتجسيدًا لفكرة "القوة الناعمة" التي تصنع لمصر مكانتها الجديدة في العالم.
فالرئيس السيسي - وفق منهجه الثابت - يسعى إلى استثمار موارد مصر الطبيعية والتاريخية لتحسين معيشة المواطنين، وتوسيع قاعدة الدخل القومي، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر في المشروعات العملاقة في السياحة والآثار باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الصعبة بعد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
ويقدّر الخبراء أن عوائد المتحف المصري الكبير، مع ما يرافقه من بنية سياحية وفندقية متطورة في منطقة الأهرامات، ستضيف لمصر مليارات الدولارات سنويًا، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
إنها رؤية اقتصادية متكاملة تجعل من التاريخ أداة للتنمية، ومن الحضارة وسيلة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يجب أن نضع هذا الإنجاز الفريد في موضع الإشكالية بين الدين والتاريخ، فليس هناك دليل علمي قاطع حول شخصية فرعون موسى، وكل ما يُتداول مجرد اجتهادات بشرية غير دقيقة، والعلم لم يقل كلمته القطعية بعد، واليقين الوحيد أن مصر تبني حاضرها بوعيٍ بتاريخها، دون أن تُختزل في نظرية أو تُسجن في أسطورة.
من المعيب ومن ثوابت الجهل، أن يٌروج أن المتحف المصري الكبير معبدًا للوثنية بدون سند علمي منطقي... بل هو في الحقيقة مرآة لهوية خالدة، وافتتاح المتحف المصري الكبير ليس حدثًا أثريًا فحسب، بل هو بيان ثقافي للعالم يؤكد أن المصريين يحتفون بتاريخهم دون أن يتخلوا عن إيمانهم.
فمصر لا تحتاج إلى مؤامرة لتتجذر في الأرض؛ جذورها ضاربة في التاريخ قبل أن تولد تلك النظريات.
لقد واجهت الغزاة، والمحن، والحملات الفكرية، لكنها ظلت دائمًا كما وصفها التاريخ والأنبياء والرسل:بلد الإيمان، والنجاة، والحضارة التي لا تُكسر.














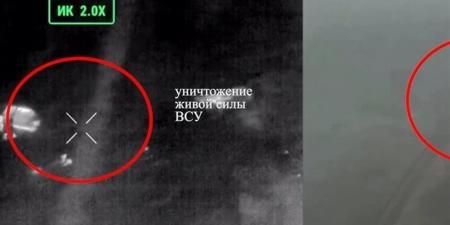



0 تعليق